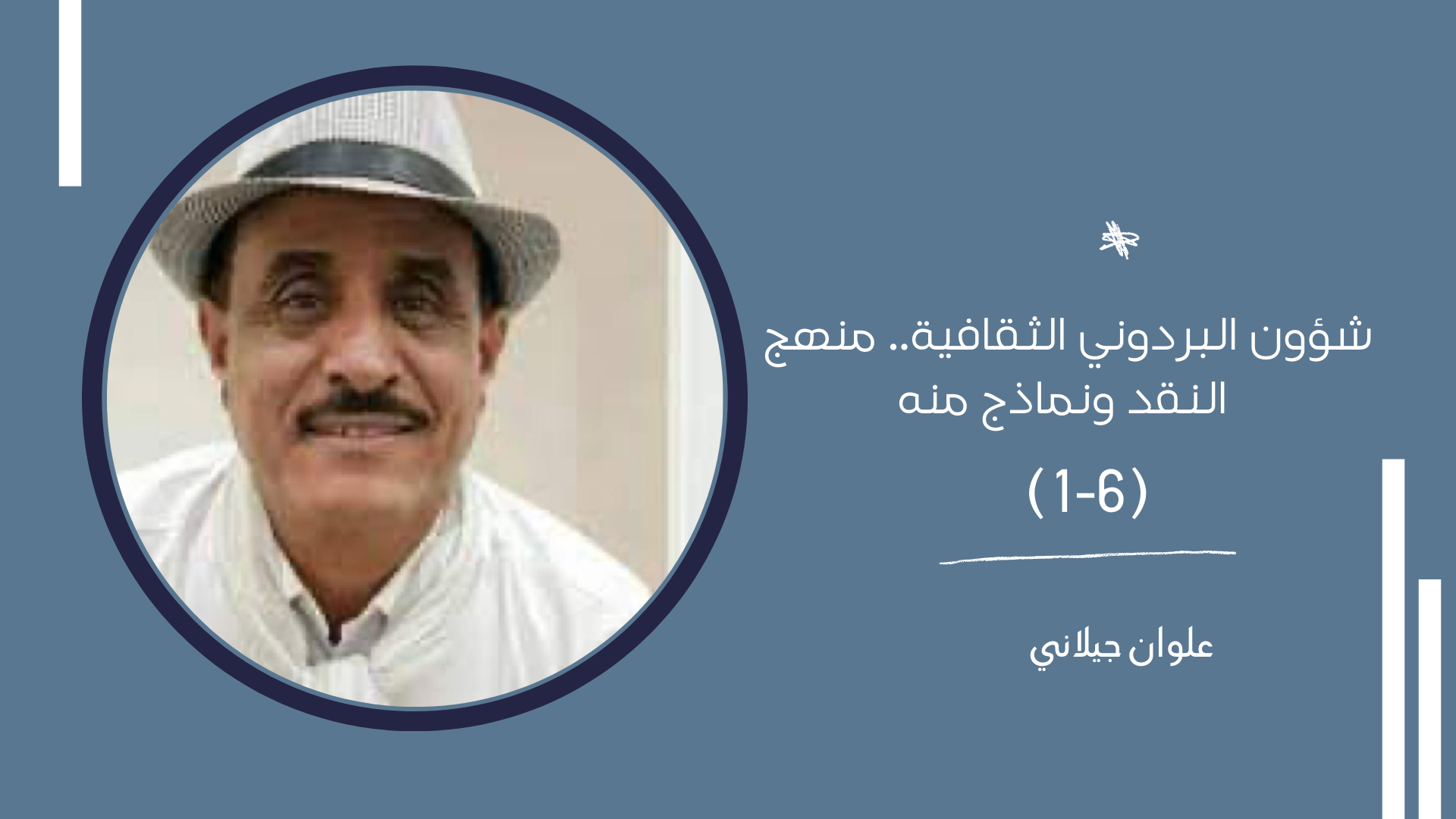
|
قارئ المقال
|
خاص : علوان الجيلاني /
طفنا معكم في المقال السابق على بعض مضامين كتاب ” شؤون ثقافية ” للأستاذ البردوني، واليوم نتحدث وإياكم عن النقد ونقده من خلال نفس الكتاب.
يطرز البردوني كتابه كالمعهود عنه بسيول من الآراء تمثل خلاصة تجربته مع الكتابة والابداع والمعرفة، بمقدار ما يمثل جزء منها صدامية البردوني ومغايراته التي طالماً أثارت غبار المعارك، فهو يكرر أن التزام المدرسة الأدبية لا يخلق روائع الأدب، كما أن التقيد الصارم بالمناهج لا يخلق اقتراباً ناجحاً من النصوص، لأن الأمر في الحالتين متعلق بالمبدع والناقد، فكما أن الإمكان في الشاعر ذاته لا في المنتمى المدرسي أو المذهب الفني، فإن الإمكان في الناقد ذاته لا في المناهج التي يترسمها، إذ المذاهب الأدبية وجهات عامة، كما أن المناهج معالم وإجراءات فحسب. وإذا كانت الاجادة الإبداعية مذهب المذاهب، فإن الاقتراب النقدي الناجح منهج المناهج. وإذا كانت اللغة لا تستطيع أحيانا كثيرة إيصال ما في النفس إلى النفس لأنها محدودة بحروف وقواعد، فمن الخطل ابتغاء ذلك من المناهج وهي أكثر التزاماً بالقواعد والحدود.
وإن ترسم المناهج في مقاربة الشعر يجب أن يظل وسيلة وليس غاية لأن الشعر ليست له محددات، إذ هو يرى بعيون النجوم وليس بعيون المناهج، ذلك أن الشعر لا يقدم مناظرة على طريقة العلوم، وليس الشعراء كالاقتصاديين والجغرافيين حين يحددون الدخول والصرف بالأرقام، ويمسحون القنوات المائية بالسنتيمتر، لأن لغة الشعر احتمالية تنبض فيها إرادة الله، وتتهامس فيها أجفان النجوم.
وهذه الآراء في طيها قصديات عديدة تتعلق بموقف الأكاديميين من كتاباته النقدية والفكرية والتاريخية، كما تتعلق برأيه الأزلي الذي يزري بفكرة ربط الابداع بالمدرسة أو بالتيار الأدبي الذي يتحيز له المبدع أو ينتمي إليه.
مثل ذلك موقفه من الشهادات التاريخية التي يتناولها متندرً إذ هي كما تقول الكاتبة جورج إليوت “مجموعة مسامير تعلق عليها كل الملابس المتسخة، ولهذا يتصيدون الأكذوبة، ويبحثون عن الإثارة من حين أن يدخل الواحد منهم التاريخ شاهداً؛ وأنا أشهد أنه أول الكاذبين” وقد تعمد البردوني اقتباس تلك المقولة من “جورج إليوت” ليحولها إلى تعريض واخز بعديد المؤلفات والشهادات التي اجترح كتابتها سياسيون وقادة في اليمن خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
ورغم شغفه الواسع بطه حسين ودفاعه المستميت عنه في غير موضع من الكتاب إلا أنه يأخذ عليه تناقضه في كتاباته عن شعراء العصر كله، وهو يلفت انتباه القارئ إلى أن سبب ذلك ينبع من كون طه حسين لم يتابع أدب عصره لانشغاله بالأدب الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وبالأدب العربي القديم من الجاهلية حتى عصر النهضة، لذلك فإن ما ذهب إليه من اعتبار “مدرسة أبولو ومدرسة الرابطة القلمية المهاجرة من لبنان والشام مفككة اللغة رخوة المفاصل إنما يعود إلى اعتياده على قراءة القديم العربي فهو غير قادر على مغادرة صياغاته وأبنيته. منبهاً إلى أن ضعف الصياغات عند هؤلاء، إنما كان في المحاولات الأولى، والتعثر في المحاولات الأولى موجود عند كل صناع الكلمة، وقد استشهد على عدم نفوذ طه حسين الى السر الشعري في باطن الكلمة بسطحية نقده في الجزء الثالث من “حديث الأربعاء” لدالية إيليا أبي ماضي “الطين”.
ومرة أخرى نجده يشكك في نفاذ الرأي النقدي لطه حسين عندما استدعى سخريته من قصائد كتبها أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومحمد الأسمر في تقريض ترجمة أحمد لطفي السيد كتاب “الأخلاق” لأرسطاليس، فقد قال طه حسين إن الشعراء الثلاثة “ذكروا أرسطاطاليس ومدحوه وهم يجهلون آثاره” وقال ” ما أظن أن علمهم بهذا الكتاب يتجاوز مقدمة الأستاذ لطفي السيد، وما أحسب أنهم جميعاً قرأوا هذه المقدمة وأحاطوا بما فيها حقاً”[1]، لكن البردوني شكك في سلامة حكم طه حسين؛ لأن شوقي كان على المام بمذاهب الفرق الإسلامية التي تناطحت بقرون الفلسفة كالمعتزلة والاشعرية، كما يتجلى ذلك من قصائده ومسرحياته، ومن كان على المام بمذاهب الفرق فليس بمحروم من الثقافة الفلسفية.
ويجوب البردوني العصور قارئاً أنساقها ومتأملاً في سياقاتها، فلطالما أتاح له ذلك تفسير الظواهر وتلمس تغايرها ورصد آثارها، ففي إحدى مقارباته المميزة يرى أن عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات كانت أكثر عقود القرن العشرين ميلاً إلى شهوة الاطلاع على السياسة كتابة وشعراً، حيث كان لكل حزب شاعر أو أكثر، وفسر ما سماه “بَرْدُ العدميةِ” في نهاية القرن “التسعينيات” بكونها امتداد تعبير عن عهد ذبول، فقد انعدمت المثيرات الحياتية معززة بفلسفة الحكم ورعب الحكم البوليسي كحالة عامة عبرت عنها قصيدة نزار قباني “المهرولون”. لكنه تحفظ على الحكم مشيراً إلى احتياج التفسير للمراجعة. ولعله حين كتب هذا لم يكن قد لمح تأثير سقوط الأيديولوجيا بعد سقوط جدار برلين، وانهيار الاتحاد السوفيتي، وظهور كونية العولمة، وزلزال حرب الخليج الثانية، وانهيار النموذج المميز للوحدة اليمنية كمؤثرات قوية في خلق ما سماه “بَرْدُ العَدَمِية”، ودَرَجَ التسعينيون على تسميته مرجعية الذات واختياراتها، بدل مرجعية الأيديولوجيا.
وفي الجزء الثاني من كتابةٍ تحت عنوان “تواريخ فنون” يتذكر صداقته بالكاتبة الفلسطينية سلمى الحفار الكزبري التي تعود معرفته بها الى أول ظهور عربي له في مهرجان أبي تمام في الموصل عام 1971م، وبعد أن يستعرض مكانتها الثقافية والعديد من تجلياتها الإبداعية، يذكر اختلافه معها حول محاضرتها التي القتها في تلك المناسبة عن حماسة أبي تمام، حيث اعتبرتها تاريخاً أدبياً، مسببة ذلك بكون معظم الاختيارات تتموضع وقائع تاريخية، لكن البردوني رأى في اشتغالات تلك القصائد اعتصارًا للموقف وليس توثيقًا للتاريخ. وتلك من إلماحاته الدقيقة التي تتلامع في كتاباته فتضيء النصوص وتضيء عقول القراء وفهومهم.
ولعل من أجمل ما في هذا الكتاب موضوع عنوانه “أسلاف الحداثة الثانية” وفيه شن البردوني هجوماً على مؤرخي الحداثة في لبنان بسبب قدحهم في الجواهري ونزار قباني، ونال في معرض هجومه من أدعياء الحداثة أو “الرفاق” كما سماهم ” يخاف المرء أن يقول إنهم قد التحوا وما اهتدوا بسلف، ولا خلقوا خلفاً؛ لأنهم ما عرفوا السابق، فكيف يرصفون الطريق للاحق؟ إن الخلف غير موجود في الحساب ولا في الحسبان؛ لأنه يجهل الطريق الذي عبره من أوله، ويجهل الوصول إليه لجهله الطريق”.
يضيف البردوني “يُسمّى نزار والجواهري عند هؤلاء قدماء” ثم يتساءل: ما صفة هذه القدامة، وما نوع رؤيتها؟ ما أعلى المهمات التي حققت؟ وهل حققت؟”
ثم يستطرد ساخراً: “إن نزاراً ظل يتابع مواسمه وهم يلعنونه في المقاهي الخافتة الأضواء، ويكتبون شعراً كثيراً لا صفة له، لأنهم لا يعرفون المعري إلا “قديماً” فقط؛ لكن هل رأوه حكيماً؟ كيف يعرفون الحكمة وما رأوا الهالة التي تلف القمر؟ لوقلت لهم: أيهما أسبق: الهالة أم الهيولي؟ لما رأوا فرقاً مادام هناك (هاء – ولام).
فهل يحتاج هؤلاء إلى مدرسة في الصغر، وإلى مكتبة لكل العمر؟ إنهم ما احتاجوا إلى النحو لأنهم يكسرون ويفتحون ويضمون –كما يقول الرفاق-؛ لكن ما أسباب الفتح والضم والكسر؟ لا يرون الفرع؛ لأنهم ما عرفوا الأصل، لهذا فهم يكتبون فناً لا يحتاج إلى ثقافة، ولا يظمأ إلى محبرة، الكتابة عندهم حداثة بلا مسمى”
يتابع البردوني سخريته: لو أنهم سئلوا عن (أدونيس) لماذا اختار (مهيار الدمشقي)؟ لما دروا لماذا اختار؛ لأنه اختار التساوي بين المعبد وحوائطه، وبين الشيطان والرحمن، وهم ما رأوا على المصحف سورة (الرحمن)، ولا رأوا (رسالة الغفران) ولا كتاب “الأيام” الذي قال عنه نزار مشخّصاً:
في كتاب الأيام نوع من الرسم وفيه التفكير بالألوان
إن تلك الأوراق حقل من القمح فمن أين تبدأ الشفتان
إن كتاب (الأيام) سيرة ذاتية لطه حسين، ومستقى ثقافي لنزار ولهذا عُرف طه حسين من أيامه؛ لأن طه عرف أيام سلفه”
مثل تفسير البردوني جوانب عظمة الجواهري ونزار قباني وطه حسين وسلفه أبي العلاء، كان تفسيره لعظمة جمال عبد الناصر، فحين أبّن الجواهري عبد الناصر لم يؤبّن ميّتاً، وإنما جمع الزعيم والأمة في بيتين، إذ كان الجواهري يعرف أن عبد الناصر صاحب مهمات يتجه إليها لكي يبلغ ما خلفها، ولهذا جمع المجد في يد، والأخطاء في يد، لأن التجربة جناح الخطأ وجناح الصواب، والعظيم من المزيجين، أما الذي لا أخطاء له فهو الذي لم يعمل؛ لأن العمل اتجاه إلى الصواب قد يعترضه الخطأ، وهذا ما لخصه الجواهري في بيتين:
أكبرت يومك أن يكون رثاءَ الخالدون عهدتهم أحياءَ. لا يعصم المجد الرجال وإنما كان العظيم المجد والأخطاءَ.
في المقال القادم نتوقف عند واحدة من أهم قضايا الأدب وهي الصراع بين القديم والجديد وكيف نظر إليه الأستاذ البردوني؟ وهل نظر إليه أصلاً بأنه صراع؟ من هاجم؟ ولمن انتصر؟
انتظرونا في مقال بعنوان:
عن صراع مدارس الأدب والذين ما عرفوا قديماً ولا أحسنوا حديثاً.
يمكنكم قراءة الجزء الأول من المقال ( شؤون البردوني الثقافية.. لمحة عن الكتاب الذي رأى النور مؤخراً )
