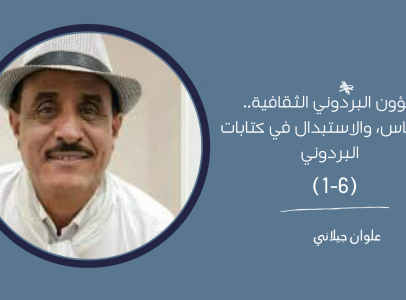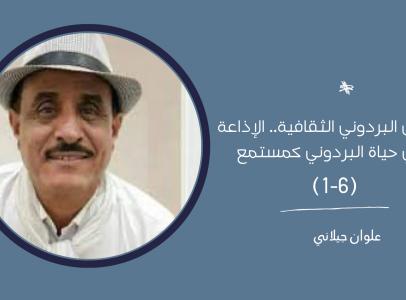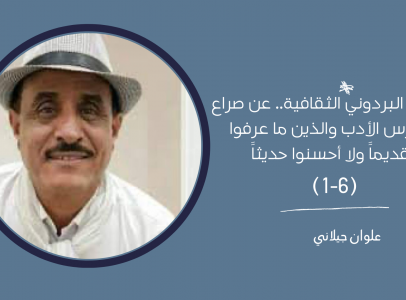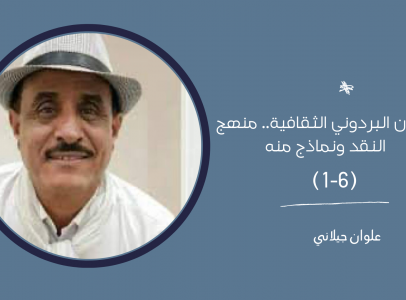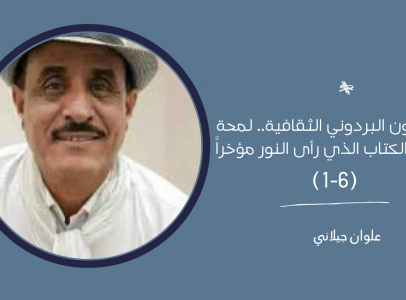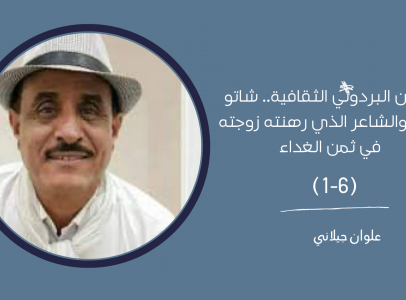
خاص : علوان الجيلاني /
تحدث الأستاذ الشاعر –علوان الجيلاني، في المقال السابق عن إثنتين من أهم السمات الأسلوبية عند الراحل البردوني رحمه الله “الاقتباس والاستبدال”، وفي هذا المقال وهو الأخير للكاتب في هذه السلسلة يُعرج على أهم أساليب البردوني الكتابية وإبداعيتها، ويختتم المقال بطرائف أدبية في حياة البردوني جاءت في شؤونه الثقافية حيث يقول:
لا بد من الإشارة هنا إلى مجموعة سمات في كتابات البردوني، ربما يعود إليها معظم شغف الناس -نخبة وعاديين – به:
أولاها: طرائق تفسيره للأحداث والمواقف.
في “طوفان على ريش الثواني” كتب يقول “ذات مرة كتب خليل جلال، أهوج نقد لرواية جبرا إبراهيم “السفينة”، حتى عثرنا عليها بعد أن أخذنا منها موقفا بأنها رواية رديئة، فقلنا لابد أن نرى الفرق بين خالق الأدب وناقده، فدخلنا الرواية وإذا هي من بديعات الفن الروائي، وإن الناقد كان بعيداً عن معرفة مواطن الإجادة بعد المشرقين، ومثل هذا مسرحية “أهل الكهف” لتوفيق الحكيم، إذ وجدنا من يتضاحك عليها هازئاً حتى كاد أن يزهدنا، وكنا قد عرفنا أن بعض الناس عيابون، فلا نقبل العيب؛ بل نحب النقد الغواص، فقرأنا مسرحية توفيق الحكيم، وكادت أن تفوتنا بقدرة العيابين على رد النفوس الضعيفة عن مرادها، وهكذا كان النقد في الأربعينيات والخمسينيات يحاول خلق المعائب إن لم يجدها، فإن وجدها أضاف إلى العيب عيوباً”
ثانيتها: استدعاء الاشباه والنظائر من الماضي والحاضر.
فهو على سبيل المثال في “عطرية التاريخ” يعرض مقولة في “محاورات أفلاطون”، ثم يستدعي أشباهها ونظائرها:
“قال السفسطائيون: القدرة غير العظمة” ثم يعقب: فكم قتل بنو إسرائيل من أنبياء؟ وكان في الأنبياء قابلية الموت من أول هجمة. وهذا بدوره جعله يستحضر رأياً مشابها في حادثة تعد من النظائر القوية:
“وهذه المسألة عالجها ابن خلدون في مقدمته، حين قارن بين الحسين بن علي ويزيد بن معاوية”
وشبيه بذلك مقارناته بين حديث ميكافيلي في كتابه “الأمير” عن القرون الخوالي وما حدث فيها واستشهاده بالضعفاء الذين تقووا، وبالأقوياء الذين ضعفوا” بحديث ابن خلدون في مقدمته عن اقتران “القوة بالشوكة العصبية العشائرية، وقوة شوكة القبيلة، وحتى تبلغ الدولة الترف يصيبها الاسترخاء فتقوم مكانها قبيلة موصولة العرى بالخشونة، والرياضة على المشقة فالأشق”
وتتجلى لمحات البردوني الذكية في مقارناته المدهشة بين الجواهري ونزار قباني في مقال عنوانه “مقارنة بين شاعرين”، فنزار بارع في استدعاء الرموز التاريخية كما فعل حين استدعى “ميسون بنت بحدل الكلبية في قصيدته “ترصيع بالذهب على سيف دمشقي” وهو يمزج الغزل باستثارة الحرب حتى لا تدري أهو في مرقص غوان أم في خندق حرب. أما الجواهري فلا يعتمد على استدعاء الرموز التاريخية، وإنما يطل من شرفة علم الكلام أو باب معرفة الله كما فعل في قصيدة “المحرقة”.
والجواهري لا يختلف شعره الا في مراحل التطور، وليس في مراحل التغير، أما نزار فظل يتطور منه إليه، بامتلاكه ناصية اللغة، وانقياده لرفيف الفساتين والشيلان.
للجواهري منهج فكري لزيم على توالي فصول شعره، فهو يطرح فكره في احتشاد الجماهير، وفي التهاب العيون حباً، ولنزار منهج لغوي ديباجي فشعره تنم عنه روائح مفرداته وتراكيبه.
نزار يعتمد على الرمز التحريري ويحول الكلام إلى حدائق غنّاء، والجواهري يتكئ على جحيم النضال ويكتب شعراً يتمنهج الفكر، وامتلاك كلٍّ منهما أسلوباً من علامة فحولتهما الشعرية، وأصالتهما العريقة.
وتشمل مقارناته بين نزار والجواهري الأوطان والحواضن والمرجعيات الثقافية. فنزار شامي موصول الثقافة بباريس والعدوة تحرراً ونضالاً، والجواهري عراقي بدوي يتملى جلال الوجود من جلال النجف وعلي وآله.
قصيدة الجواهري بدوية على ظهر جمل تقبّلها الشمس من كل الجهات، وقصيدة نزار باريسية تتأرج بعطور كريستيان ديور وتأكل المتبّل والحمص.
أما الأجمل في المقارنة فهي لغة البردوني الواصفة فهو يختم سيمفونيته البديعة على هذا النحو:
“هناك قامت الفروق بين نزار والجواهري، وأصح الموازنات هي التي تقوم على نقيضين متفقين مختلفين، أو بين ندين كلٌّ منهما يصلى إلى قبلة أخرى، فما الذي جمع البعدين؟ إنه الموت وحده، الذي الحق نزار بالجواهري كنعش واحد تحمله القلوب النجومية، والشعر الذي يتهازج كما يتهازج نسيم الأسحار، وآيات القنوت”.
ثالثتها: مقترباته من النصوص الشعرية وأسلوبه في قراءتها واستكناه دخائلها.
في “الميلاد الثاني لنزار قباني” قال إن “نزار لم يلمّح بشرارة فجور، ولا بروائح مخدع جمال، بل قال ما يمكن مشاهدته عياناً:
أخذ الكبريت وأشعل لي ومضى كالصيف المرتحل
رجل يمنحني شعلته ما أحلى رائحة الرجل
فكان يصدر من قراءة الجمال في وجه المليحة، أو من كؤوس الزهر، أو من شفاه القرنفل، أو من أغنيات الياسمين، وكان تغنيه بالجمال المبسوط للناس لكي يعرفوا أسراره، كما نعرف نكهة البرتقال من الصفرة البنفسجية، والحمرة القرمزية أو الشفقية، والخضرة التي تلمُّ لوامع حسنها من قطرات الندى وأشعة الشمس.
لماذا خضرة البساتين أجمل من فواتن الحسان؟ لأن تلك جاءت من ذرة بشرية، وتلك نبتت من ذرة التراب استعرضتها الشمس والقمر وعيون النجوم الثواقب.
لهذا أعطى نزار الفلسفة الجمالية نصف ملكته الشعرية، ونصف تخيّله الجنسي، ونصف حسّه بالذكورة”
رابعتها: الشعرية العالية التي تتزين بها نصوصه حين يتسلطن أو حين يحزن ويتشجن “
وكان هذان البيتان أحلى تتويج لعمر صداقة، أو لعمر قلبين امتلآ بأنقى العواطف كما لو كان كل واحد هو الآخر، وأصبح أنس المستشهد، فيكفي ديباجة الرسالة ألَّا تطول، لأن النص قد قال ما فاض به القلب”
وهناك سمة يعرفها قراء البردوني جيداً هي سمة الاستطراد، وغالباً ما يرتبط الاستطراد بأخذ المواضيع بأطراف بعض حين تكثر شجون الكلام وتتعدد أغراضه، لكن الاستطراد ينتج أحياناً عن استدعاء الأشباه والنظائر..
وهذا يحدث دائماً في كتاباته وأمثلته في الكتاب كثيرة نذكر منها ما فعله في مقال “الميلاد الثاني للشاعر نزار قباني”، فحديثه عن تحول نزار من شاعر المرأة إلى شاعر الأمة، استدعى ذكر ممهدات ذلك عند سابقيه من الشعراء الذين كتبوا “الشعر الهادف” وحولوا الهجاء من غرضه القديم وهو تتبع معيب المهجوّ إلى نضال ضد أعداء الوطن، كما روضوا المديح فنقلوه من تملق الملوك وذوي اليسار إلى الزعماء الوطنيين الصادقين، وإلى المناضلين في كل خندق. معتبراً أن أحمد شوقي يعد نموذجاً سابقاً للتحول الذي وسّعَهُ نزار، لكنه ما أن استدعى تجربة أحمد شوقي حتى استطرد في الحديث عنه وعن مسرحياته، وعن أشباهه ونظائره، وعن تطور الشعر من بعده وسطر في ذلك كلاماً طويلاً قبل أن يعود إلى نزار.
و من السمات في الكتاب وهي سمة مألوفة في كتابات البردوني عامة، الافتتاحيات التي تجمع بين التفلسف وشعرية اللغة كقوله في مطلع “بدايات متشابهات” لشدة حساسية هذا الزمن، أو لضياع أحاسيسه، تبدَّى أصمَّ أعمى لا يرى ولا يحس، ولا يتصور ولا يهجس، لأن المستحيلات قد أمكَنت ولو عند البعض..فلا يهزه من قراراته إلا الأحداث الخارقة التي تترتب على خرقها خروقات تُغير جوانبَ خفيةً وواضحةً من جوانب الحياة المعيشية والثقافية، وتمسه شخصياً أو تمس الموصول بهم.
كان هناك ما يسمى “التغاضي”، وكان ما يسمى “عدم الاكتراث”.. وهذا صحيح عن ثقة وليس عن ضياع، لكن السبب الآن مختلف لأن الغيبيات اتضحت والإخباريات تكشفت للعيان..فلم يعد الغريب غريباً، إلا إذا أحدث انفجاراً في الأزياء والألوان والأشكال، بل في الرغيف اليومي، وفي فنجان القهوة الصباحي”.
كتاب البردوني حافل باللمحات الذكية والطرائف التي تفجرها المفارقات، وفي الجزء الثاني من “رحلة على الورق” يكثف بعمق مآثر الكاتب الفرنسي الشهير “دي شاتوبريان” بوصفه واحداً من عظماء الكتاب الفرنسيين، فهو كما يصفه ” يطرح أفكاراً في قوالب من خطرات القلب، وهجسات العين، وحديث الزهرة إلى الزهرة، ونجوى قطرات الندى إلى شفاه الزهور.لأن (شاتو بريان) شاعر عظيم، لكنه كان في زمن استرق منه عظمته، انتهازاً لغير العظمة “، لكن البردوني وبعمق مماثل يكثف مثالب شخصية “شاتو بريان” الإنسانية، من خلال إساءته إلى العرب، الذين اعتبرهم ” دود يزحف على الأرض ” قال البردوني معلقاً ” وكأن (الدود) لا يستحق بنانة من الأرض يدب عليها، وهذا هو الغرور الفارغ، وسوء النظرة إلى الناس”
أما قول شا توبريان “: “طفت بمصر، ضفافاً وأودية ومدائن وقرى، فما رأيت إلا مرضى يتهالكون على مرضى”. وهذه ملاحظة ممكنة، لكن الملاحظة المستحيلة لفظت نفسها من شفتيه: “فكل مصري ومصرية مرضى بالسفلس”.
فقد علق البردوني عليه مستغرباً: “فهل كان هذا المستشرق المستطلع إلى هذا الحد من السقوط في(العورات)، لأن السفلس لا يقع إلا فيها أو على حوافها. وكيف أمكن أن يرى عورة شعب من عشرين مليوناً، آنذاك؟”
و من تقابل عظمة شاتوبريان وسقوطه معاً تفجر موقف ضاحك التقطه الروائي السوري زكريا ثامر أروع التقاط، فقد كان البردوني وثامر مع مجموعة من أهل الأدب والفن في بيروت للمشاركة في الأسبوع الثقافي اللبناني، “فقال الشيخ عبد الله العلايلي “أنتم اليوم ضيوفي على أشهر مطعم يجيد طهي الشاتو بريان..” وكنا كلنا نعرف أن (شاتو بريان) مفكر وفنان فرنسي، ولعل التسمية انتزعت منه..
ومن سوء حظنا وحظه كان المطعم قليل العمال، ولعل أمهرهم كان غائباً في عطلة مناسَبَة، ولكن لم يسع مدير المطعم إلا أن يرحب بنا.. وكان في المطعم الشاعر أحمد الصافي النجفي، وهو يرتعش تحت الثمانين، في شملته، مجرد جلد على عظم. وهكذا كان الشاتو بريان الذي لاكته أسناننا كلحوم الجَمَل، تغري روائحه، وتنفِّر صعوبة مضغه، أو قرضه. فقال زكريا تامر للشيخ عبدالله العلايلي: “دعوتنا على شاتو بريان، فإذا بهم يقدمون لنا أحمد الصافي النجفي”..وكانت تلك أبدع نكتة، لأن (شاتو بريان) كان ممتلئاً سميناً، على حين كان أحمد الصافي النجفي جلداً على عظام..فما أسوأ هذا التطابق المتعاكس.. ولعله إحدى سيئات (شاتو بريان) في رأيه عن المشرق العربي وإنسان ابن النيل”
أما أجمل طرائف البردوني في هذا الكتاب فهي تلك التي رواها في فصل “أزمنة الثقافة .. زمان واحد” فقد ذهب مع زوجته فتحية الجرافي لتناول الغداء في مطعم باريسي، وكان على زوجته ان تتركه وحيدا في المطعم ريثما تذهب هي إلى مصرف قريب لغرض تبديل النقود التي معها من الدولار إلى الفرنك. أثناء غيابها تعرف عليه ثلاثة من الشبان العرب وانهمكوا في الحديث معه عن اللغة العربية ومشكلاتها، وحين عادت زوجته جلست غير بعيد منهم ريثما يكمل حديثه مع الشبان الثلاثة. وفي اليوم الثاني خرجت زوجته إلى الشارع ثم عادت وفي يدها صحيفة على إحدى صفحاتها صورتهما وقد كتب تحتها “هذا الشاعر رهنته زوجته في ثمن الغداء”.